مسلم و12 مسيحيا
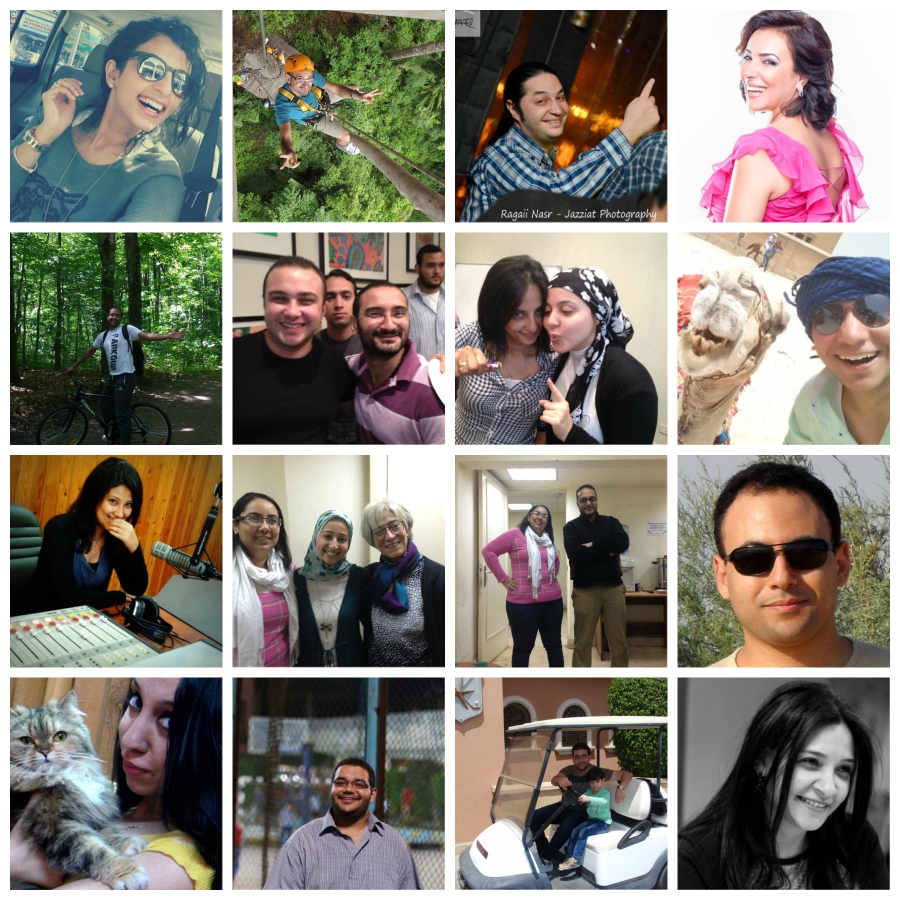
الشمسُ توشك على المغيب في أول أيام رمضان. وبينما تحملنى قدماى عبر ميدان التحرير، مسرعا كي ألحق بمترو السادات، لأتأكد بنفسي أن المحطة فتحت أبوابها، ولم يكن الأمر حلمًا في خيال مخمور، استوقفتني الكراسي المنصوبة في الشارع والشباب والبنات الضاحكون، وفي الخلفية موسيقى لطيفة وأغنيات مبهجة، بينما ترفرف فوقهم لافتة مكتوب عليها “مائدة إفطار المحبّة تحت رعاية كنيسة الميدان الوطنية – كنيسة قصر الدوبارة”.
وتذكّرت على الفور ما كانت تفعله كنيسة قصر الدوبارة في أثناء ثورة يناير، حيث فتحت أبوابها أمام الثوار، تعالجهم وتؤويهم وتذود عنهم.
قبلها بساعات، اتصل بي صديقي الدكتور جون وليم، فبادرته:
– لو سمحت ماتهنّنيش برمضان قبل الفطار، عشان فيه فتاوى بتقول إن ده حرام.
– طيب بص كده كده أنا اتصلت وغِرمت تمن المكالمة، لو قلت لك هابي بيرث داي وكده، تمشي معاك؟
– آه طبعا، قشطة جدًا.
– طيب هابي بيرث داي ليك ولأسرتك وينعاد عليكم باليُمن والبركات.

ثم هل يمكنني أن أنسى صديقي ميشيل حنا؟ الأديب الصيدلي المصوّر، الذي يحمل فوق كتفيه عبء إنقاذ أشجار العالم وتصوير المباني القديمة لحفرها في الذاكرة قبل أن تطولها يد التخريب والحداثة؟
ميشيل يتصل بي في كل مناسبة دينية تقريبا، ويهنئني ضاحكا كطفل. صحيح أنه في رمضان تشوب تهنئته شماتة خفية، ولا مانع لديه من التوقف في أثناء الحديث ليأربع لتر مية بصوت مسموع، ثم يكمل حديثه بمنتهى البراءة، لكنه مع ذلك، طيّب إلى حد ما.

يتبقى من؟
جميلة الجميلات، نانسي حبيب، رفيقة أيام “موقع بص وطل” ثم “الدستور” و”التحرير”، التي طالما خُضت معها في أدق تفاصيل المسيحية، دون وَجل، والتي أهدتني أول إنجيل في حياتي، وكذلك ميدالية فضية عليها “الحمد لله”، ومنحتني ابتسامتها القدرة على مواجهة الكثير من مشاكل هذا العالم.

هناك أيضا، رفيق “دوت مصر”، مينا غبور، الذي يعرف عن الإخوان المسلمين، أكثر مما يعرفون هم عن أنفسهم، حتى شك جميع من يعرفونه أنه من خلاياهم النائمة، لولا أن نهمه بالباستا والهامبورجر ربما ينسف هذا الاعتقاد تماما.
مجرد رؤية مينا، أو الجلوس في حضرته دقائق، قادرة على تغيير مودي تماما، ومنحي ألف مبرر ومبرر للبهجة.

وعلى ذكر مينا، هناك أيضا الولد العزيز على نفسي جدا، مينا يونان، صديق “جود نيوز” الذي كان دائما ما يبهرني بثقافته وكفاحه وإصراره أن يتعلم كل يوم شيئا جديدا، وضع الهجرة هدفا أمامه، وحققه بالفعل، ومن يومها وهو يغريني أن ألحق به، فأثور في وجهه، وأقول له بحرقة: “أبدا، مصر هي أمي، نيلها هو دمي، حتى لوني قمحي لون نيلك يا مصر”، دون أن أعترف أن السبب الوحيد لوطنيتي الطارئة أنني غير قادر على إتقان الفرنسية، وهي أساسية للهجرة.

هناك كذلك “المزّة”، أو مدام نهى، مديرة الإتش آر في شركة تايا آي تي، التي لم أرها مرة إلا ضاحكة، رغم المشاكل، وكانت كل محادثة معها، ولو قصرت، درسا في الحياة. أما “المزة” فكان لقبها غير الرسمي بين الأولاد والبنات، إعجابا بقدرتها على الحفاظ على رشاقتها وجمالها رغم كل شيء. لا أنسى أنها جعلتني مرة أكتب شعارات للشركة بالشعر، وطبعا كانت مسخرة، لكنها أعجبتها للغاية، وظلت تعتبرني “الواد الشاطر بتاع العربي”، ومرة أعدت إفطارا رمضانيا في بيتها “للناس المهمّين” ودعتني، فذهبت حاملا بوكيه ورد مثل الأفلام، ومع أنني لم أعرف حتى اليوم أغلب الأصناف التي قدّمت، فقد أكلت كفرس نهر حقيقي، فيما أتفرّج على البهوات والبشوات بفرحة.

وهناك كذلك البنت المبهجة، سارة سعيد، التي لم أقابلها ولا مرة واحدة، وكل ما بيننا بضع رسائل عبر فيس بوك، لكن متابعة بوستاتها تبهجني فعلا، وتجعلني أشعر أننا على صلة منذ سنوات. منذ يومين دخلت نقابة الصحفيين، ففرحت لها كأن الكارنيه صدر وعليه صورتي واسمي.

أما فريد إدوارد، فحكاية.
تعرّفت إليه منذ سنوات دون أن نلتقي، تليفونات فقط وتعليقات متبادلة على البوستات، حتى عملنا معا ذات يوم، فاكتشفت هدوء أعصابه المبالغ فيه، الممزوج دائما بحكمة خفية، فاعتبرته بوذا الخاص بي، وأصبحت أحرص على أخذ رأيه في تفاصيل كثيرة يصعب على أمثالي فهمها. ألطف شيء في فريد خفة روحه، وسخريته اللاذعة، خاصة عندما أنكشه وأذكّره أنه مسيحي، وأنه سيدخل جهنم وبئس المصير، فيغيب فريد ويظهر بوذا قائلا بحكمته: يا برنس كلنا في الهوا سوا.

مايكل هنري، حالة خاصة، بين المسلمين والمسيحيين والبشر عامة، فهو أكبر ممثل لل Smiley face الذي نستخدمه طول الوقت على فيس بوك، نادرا ما يعبس أو يغضب، إضافة إلى ذلك، فهو طَموح جدا، ومن النوع الذي يمكن أن يتشقلب أمامك كي يقنعك بفكرة مجنونة ومباغتة. ثم يتخلّى عنها تاني يوم إذا تأكدت له عبثيتها!
مرة شاركته في تصميم تطبيق للآيفون اسمه “كابشني” يقوم على وضع عشرات الجمل الساخرة، وإذا التقت صورةب الموبايل تظهر معها إحدى هذه الجمل بشكل عشوائي، صرف وكلّف وعمل موقع إلكتروني، وحاز الأمر إعجاب الكثيرين، وبعدين نسي الأمر برمته، مجنون فعلا.. أليس كذلك؟
كانت بيننا صولات وجولات “من تحت لتحت”، وحاول مرة أن يتوسط لي في شراء شقة في أسوأ مكان على البسيطة، ومرة كدت أتهور وأطلب منه تعليمي السواقة، لكن مرأى بعض من يركبون معه، واقترابهم من لمس حقيقة الكون ذات نفسه في صحبته، جعلتني أصرف نظري تماما عن الأمر، عشان مصر لسّه محتاجاني!

والبنت المجتهدة ماريان، التى تعمل بلا كلل ولا ملل، مصرّة على أن تفعل شيئا حقيقيا، وتطوّر من أدائها باستمرار، رغم الظروف التي تعاندها في أحيان كثيرة، ثم هي لا تتأخر عن مساعدة أحد، وتستوعب جيدا ما يقال لها، وتخدم أصحابها لآخر مدى. ناهيك عن ابتسامها الذي يسبق كلامها، ويجعلك مهيئا تماما لأن تقول لها “حاضر” و”طيب” يا ست.
عندما كان أخوها يمتحن في الثانوية العامة، طالبت أصدقاءها بالدعاء له، فكتبت لها: “دعوة المسلمين تمشي معاكم عادي؟”، فقالت بأريحية: “آه طبعا ده هي دي اللي عليها الطلب، إنت عارف إننا كَفَرة، وربنا مش هيقبل مننا”.
تدوم الروح الحلوة يا ماريان.

ومن ينسى “وزة” أو وسيم عادل سابقا، أول يوم لي في العمل معه، أشاروا لي إلى مكتب صغير، مليء بلعب ماكدونالدز ودباديب وعرائس، بشكل مبالغ فيه. وعندما عرفت أن معنا زميلة في الحجرة، قلت بكل ثقة: أكيد ده مكتبها.. صح؟ ليقول لي وسيم بابتسامة فخور، وبلا أي نوع من تأنيب الضمير: لا طبعا، ده مكتبي أنا.
وسيم حاول أكثر من مرة إغرائي بالانحراف معه، لكنني كنت من الغباء بما يكفي، كي أرفض في كل مرة، الآن، أعترف بخطئي، فهل تقبل يا أخ وسيم توبتي، وأن تكون مرشدي في الانحراف، جزاك الله عني كل خير؟

هناك أيضا “سارقة الكاتشب”، ريهام، التي كنت أخوض معركة حامية معها كل يوم، كي أستأثر بأكبر قدر ممكن من الكاتشب، الذي يأتي مع الساندويتشات، لكنها في كل مرة كانت تنتصر علي، وتعرف مخبئي، وتتعاطى الكاتشب كما نشرب نحن الماء!
ومرة عرفت الله على يديها، إذ ركبت معها سيارتها العجيبة، ولشدّة تهورها، وعدم اعترافها لا بقواعد المرور، ولا بوجود بشر آخرين من حقهم السير إلى جوارها، أدركت أنها موفدة العناية الإلهية، لإخراج جواز سفري إلى الأمجاد السماوية بلا رجعة، وإذ نجاني الله، سجدت شكرا له، وأيقنت أنه كتب لي عمرا جديدا.

حسنا لماذا أقول كل هذا؟
لأذكّركم –إخواني في الله- بالفتنة الطائفية التي اختفت منذ فترة، ولم نعد نسمع أخبارها كما يجب، رمضان مناسبة عظيمة كي نتذكّرها، ونحثّ على إعادتها إلى قلب المشهد، كي نتغلّب على الملل الذي أصبحنا نعاني منه، ونؤدي ما علينا تجاه القضايا الكونية الكبرى التي تستحق الكفاح من أجلها.
نعم، فالمسلمون والمسيحيون لا يطيق أحدهم الآخر، منذ فجر التاريخ، وكل ما سبق دليل قاطع على ذلك.
أيقظوا الفتنة أصلحكم الله.





